كثيراً ما راج الاعتقاد بأن ليس ثمة ما يجمع بين الأدب والسياسة ولا ما يصل بينهما، وفي ما عدا التناقض الرحب والشاسع بين سُبلهما ومآلاتهما فلا وجود لما يتشاركانه، ولذلك ساد ما يشبه اليقين بأنهما لا يقفان على طرفي نقيض فحسب، بل إن حروناً وتجافياً أزلياً ظل قائماً بينهما وسيظل أبداً، ولعل في ذلك ما يمكن الظن بصحته وإنْ ليس على نحو حتمي، فللآداب على اختلاف أجناسها وتعدد فنونها خصوصيتها في التعاطي مع الصراعات الفكرية والحضارية والحروب العسكرية والأزمات السياسية وما يرافقها من أحداث؛ يمتد إلى شفافيتها وتلقائيتها في الحديث عنها وإبداء ما تشعر به حيالها، على عكس السياسة التي تمتلك تنظيماً شعورياً وانضباطاً انفعالياً مذهلاً يظهرها في أكثر مواقفها حدة ووضوحاً على نحو تعتريه الشكوك فلا تبدو أبداً بعفوية الأدب ومباشرته، بيد أن الإنسان كقيمة وغاية يمكن أن يكون الاستثناء الذي يجتمعان من أجله ويلتقيان حوله.
تُبقي الآداب على الأفكار أياً كانت متيقظة ومتأهبة، وتشحذ همة العقل وعزيمة الفكر، وتمدنا بالنور الذي يقينا الظلمة والقيم التي تدفعنا لنبذ الظلم، وتظهر مخالبها للدفاع عن الوطن ولمنافحتها عن الحقيقة، وتمنح السياسة القوة الروحية التي تمكنها من حماية الأوطان والعمل على ازدهارها ونمائها وهي بذلك تستهدف الإنسان، فيما تشير السياسة إلى موضع الخطأ الذي تجترحه العاطفة وتعيد برفقة الآداب تشكيل بُنى الوعي من خلال إبقاء الأوطان الفكرة المحورية التي تنطلق منها الآراء وتنبعث عنها الرؤى وهي بذلك تهدف إلى نماء الإنسان ورفاهيته أيضاً، ولذلك فهما يجتمعان حول الإنسان وبرفقته يجتمعون حول الوطن، ولبلوغ ما يؤمل يحتاج الأدب إلى مخيلة حقيقية فيما تعمل السياسة للوصول إلى حقيقة متخيلة، ولذا فالفكرة السائدة والتصور الرائج عن العلاقة التي تجمع الآداب بالسياسة ليست دقيقة.
يستهل الأدباء حديثهم عن أنفسهم بالوطن ويستعيرون اسمه ليُعرفوا بأنفسهم ومن ثم يستيعنون بمعناه ليصفوا نظرتهم نحو الحياة ورؤاهم وسيرهم الممتدة من انبجاسة القلم الأولى إلى علامة الترقيم الأخيرة، فكل ما يملكونه يبدأ من الوطن ويعبر من خلاله ويعبر عنه؛ قيمهم وقيمتهم، ولطالما كان تجليهم مؤثراً حين يحضر الوطن في نتاجهم، فيبدو ذلك المتجذر في وجدانهم وقد أضفوا عليه من ألقهم وأسبغوا عليه من وهجهم مشعاً وبراقاً، وكذلك تفعل السياسة إبان تعريفها عن نفسها وحين تحمل راية الوطن نحو المراكز العليا على صعيد العالم، ولذلك فالآداب والسياسة على تماس مباشر وعلاقة وطيدة في أي مشروع وطني وليسا متنافرين كما توحي النتاجات الأدبية المضطربة التي ظلت ردحاً من الزمن تتصنع الثورية وتتقمص القومية للتعبير عن عُقدها.
الواقع ألّا حصر للتفاصيل التي تخلق فرادة الأدب وتفرد الأديب ولا حصر أيضاً للأحداث وثيقة الصلة ببراعة السياسي ومهارته في مزاولة السياسة، ولذلك ففي إزاء كل عمل أدبي نابه يُبرز قيمة الوطن، ثمة نجاح لسياسي نابغ يبني سياجاً حوله، ومن أجل هذا يفترض المنطق دعماً أدبياً لا متناهياًَ للعمل السياسي الذي يُبذل لتجاوز مأزق ما أو الظفر بحقٍ مغتصب، والنظر بعينٍ يقظة وعقلٍ فاحص إلى ما يراد به، سيما حين يقع وطن ما تحت نير الاحتلال فيمسي بحاجة إلى من يعينه على استعادة حقوقة.
في الإقليم الأشد اضطراباً على كوكبنا تنشأ الأزمات السياسية بشكل مستمر وتتعقد بسرعة فائقة حتى لا يعود في الأفق ما ينبئ عن سبيلٍ إلى حلها ولا يُرى ما يؤشر إلى ذلك، فتتحول الانفعالات السلبية التي تجتاح الشعوب إلى شعور باليأس ويسود الإحباط وينمو الاعتقاد بأن ما هو على وشك الوقوع كارثي وبأن المنطقة تتجه نحو الدمار، ويُتخيل ألّا وجود لمن هو معني على نحو جدّي بإيجاد الحلول أو الدفع نحو استقرار المنطقة وبالتالي الالتفات نحو تنميتها.
وعلى مساحة أضيق من هذا الإقليم يبدو الأمر أكثر تعقيداً؛ فالصراع الممتد لسبعةِ عقود ونيف يزداد ضراوة واحتداماً والكيان المحتل يمعن في ممارساته الوحشية ضد الشعب الأعزل في الضفة الغربية وقطاع غزة ومع إطلالة كل يوم تظهر حصيلة جديدة لعشرات الأطفال والنساء والشيوخ الذين قضوا بآلته العسكرية، وفيما تُشَيع فلسطين أبناءها يُشِيع هو الفوضى فتتفشى رائحة الدم وينتشر الدخان وتتهدم الأبنية وتجد الأيديولوجيا مناخاً خصباً لمزاولة نزقها فتضطلع المليشيات بأدوار الحكومات وتزايد على مواقف الأصدقاء وتساق خلفها الغوغاء فتخفت الآمال ويضمحل بريقها ويبدو المستقبل سوداوياً.
الحديث هنا ليس عن الدمار واليأس والإحباط ولا عن الخراب الذي يصنعه الكيان ولكنه عن الأمل، عن الضوء الذي يخترق العتمة ويجلو أثرها عن النفوس، وعن الرؤية العظيمة التي تتسع لتشمل دول المنطقة، عن النُبل الذي يرتدي عباءة خليجية والسمو الذي يعتمر شماغاً سعودياً ويواجهه الجحود الأكثر تطرفاً وغرابة من قبل منظمات وأحزاب فلسطينية وعربية؛ ففي إزاء الجحود والنكران والكفر بالمعروف الذي تواجهه المملكة العربية السعودية تبذل جهوداً مضنية ومضيئة، وتقود مساعي استثنائية لإيقاف الحرب وإعادة الأمل وإنقاذ الشعب الفلسطيني من الظلم الذي يقع عليه غير عابئة بالتعريض الذي يطال نهجها ولا المزايدات التي تستهدف انتماءها، ساعيةً بثبات نحو الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات إلى القطاع المنكوب كامتداد طبيعي لموقفها الثابت من قضية فلسطين، فيما يحجم الكثير من الأدباء الفلسطينيين والعرب عن الاضطلاع بدورهم في المشروع التحرري بما في ذلك تشكيل بنى الوعي ولفت الانتباه للخطر الذي يشكله تفريغ القضية الفلسطينية من عمقها العربي من خلال استهداف الدول العربية المركزية وتغذية الشرخ المتنامي بين مواطنيهم والشعوب الأخرى والتعريض بالمواقف العربية.
قد يصاب الأديب بالضجر عند الحديث عن السياسة بتعقيداتها اللامتناهية وقضاياها المتشابكة، فقد جُبل على البحث عما يُزيح عنه الأسى ويذهب القلق المتراكم في داخله، ولكن ثمة مسؤولية أدبية وأخلاقية تقع على عاتقه تجبره على القيام بدوره وبصرف النظر عن مآلات ما يحدث، فمتى كان الكاتب متيقظ الضمير نابه الحس، جاء نتاجه منصفاً وعادلاً تجاه الآخرين فكيف به نحو من تجمعه وإياه روابط وطيدة ووشائج عميقة؟
إن أنكى ما قد يصيب القلب هو الجحود الذي يزاوله من أسديته صنيعاً وبذلت من أجل تجاوزه أزماته جهداً مضنياً وسخّرت من مقدراتك ومقدرتك الكثير لخدمة قضيته، ولكنه النبل والسمو اللذان ما فتئا يسبغان على المسيء رداء الصفح ويمدان له يد التسامح، والتسامي عن الإخفاقات الأخلاقية، ففي فلسفة السياسة لدى السعوديين، تعد القيم أمراً مقدساً والاستقرار غاية منشودة وازدهار الإنسان وإزهار البلدان هدفاً مشتركاً تمد لتحقيقة يدها إلى كل من يثبت جديته.
النهج السعودي مختلف تماماً عن الأدبيات التقليدية للسياسة بما فيها البراغماتية والمقايضة وهو بطريقة ما صياغة متفردة تماماً للمفاهيم السياسية تنطلق من القيم الإنسانية، وهو -في الآن ذاته- صلب وواثق يستشرف مستقبل الإقليم ويعمل بأناة وحكمة تفوقان ما تملكه دول المنطقة وفي تأريخ هذا الصراع ما يثبت ذلك، ولذلك كانت وما زالت المملكة العربية السعودية الأمل الذي يدرك المنصفون كم هو صادق وآتٍ وأن ما يفعله بعض الأدباء ليس ضرباً من الجحود فحسب ولكنه كفر بالأمل.







.png)
 1 السنة منذ
28
1 السنة منذ
28






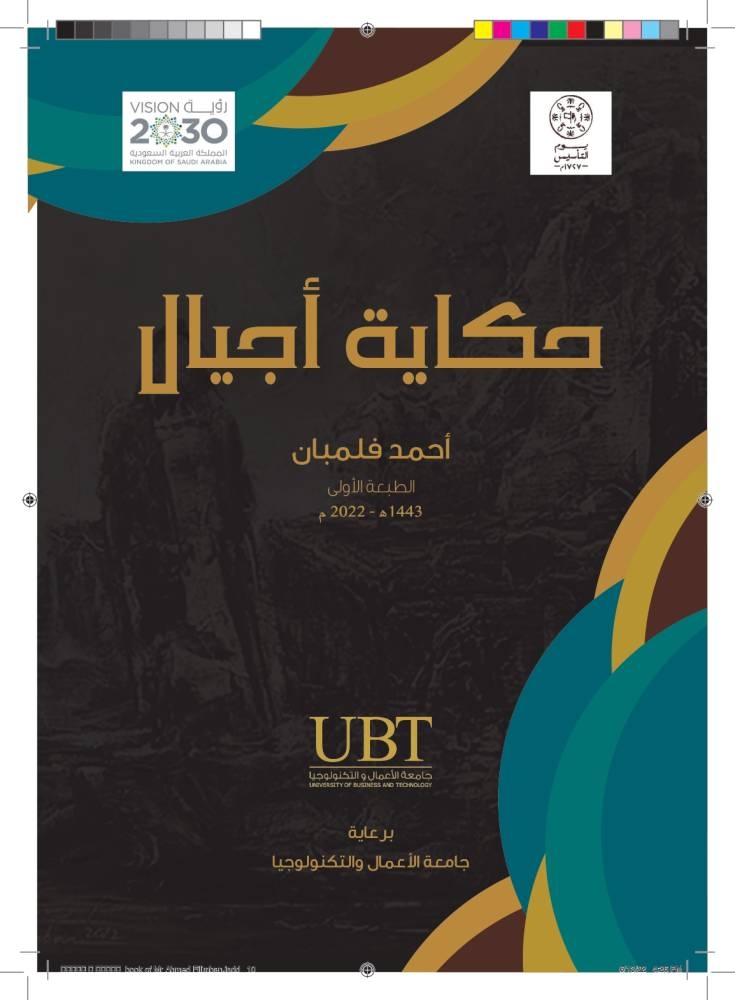

 English (US) ·
English (US) ·