تتشابه تجارب البشر وأقدارهم، بمستوياتها الفردية، أو الجمعية، أو السياسية، وتتقاطع أحياناً، ومنذ وعينا بالتاريخ، ونحن نعلم أن الإسلام، ظهر في بيئة تحوطها إمبراطوريتان؛ الفُرس، والروم، وداخلهما كيانات، ومعتقدات وديانات تؤجج دوماً الفخر بالانتماءات، وتخلق خلافات وأزمات ضمن إطار تنافس الكبار.
ولعل عرب الجزيرة العربية آثروا حكم القبيلة، برغم ما وهبهم الله من دهاء وحكمة، إلا أنهم لم ينشغلوا بتطوير النظام الاجتماعي المتوارث، فاعتمدوا توقير وإجلال كبيرهم، واستثمروا مواردهم المحدودة، وتقاسموا ما تجود بهم صولات وجولات فرسانهم دون فك الارتباط بالمرجعية العُليا، إذ توزعت الولاءات على قطبي الرحى، (الغساسنة والمناذرة).
ولا خلاف على أن النبي عليه الصلاة والسلام مستجاب الدعاء، ولو أراد أن يدخلنا في فضاء التمنيات والأحلام والكرامات دون عمل لاكتفى برفع يديه للسماء، ولكان كفاه دعاءه مؤنة التهجير من أحب البلاد لقلبه، ولأقام له كياناً مبهراً، ولفُتحت له الأمصار، دون مشقة ولا عناء، ولا حروب ولا دماء، إلا أنه عليه الصلاة والسلام أكثر مرونة وواقعية من بعض المعاصرين، خصوصاً (الحزبيين الإسلامويين).
تعامل المُصطفى عليه الصلاة والسلام بوعي فطري وإدراك نبوي وحدس نقي تعاملاً واقعياً مع قوى مهيمنة (فارسية وبيزنطية)، إذ لا تقل هيمنتهما وشراستهما عن القُوى المعاصرة، إضافة إلى تفاقم الإشكاليات من حوله، إما برفض البعض لدعوته، أو إنكار آخرين لنبوته، أو استخفاف معشر بأرومته، أومناصبته العِداء، حتى من أقرب دوائره النسبية في مكة، ثم اليهود والمنافقون في المدينة، فتجلّت الحكمة في المداراة، وتعزيز الصلات، وعقد التحالفات، ليتوطد حضوره تدريجياً وتتسع صلاحياته مرحلياً، متفادياً الصدامات قدر الإمكان، ومتبنياً المُبشرات لرفع المعنويات.
لم يُقِم المصطفى عليه الصلاة والسلام دولة بمفهومها السياسي ومعناها القانوني، ولا مكوناتها التي وصلتنا لاحقاً عن الأمويين، والعباسيين، وإنما مارس سلطة دينية تتسع وتضيق بحسب معطيات الراهن، وضخامة الرهان، فأذعنت له أعداد متزايدة دخلت الدِّين الجديد بقناعة، إذ رأت في رسالته العالمية ملاذاً آمناً وخلاصاً لا متناهٍ، خصوصاً وأن الكتاب الذي نزّله الله على رسوله مُعجزٌ على مستوى اللفظ، والدلالات، ومُستلهمٌ لما سبقه من نبوات، والرسول الذي يُبلغه أرقى مخلوقٍ عرفته الإنسانية، نال بحُسن خلقه، ما يعجز عن نيله وريث أقوياء، أو سليل أثرياء.
كانت الهجرة محكاً، وإن كان لها وقعٌ سلبي على المشاعر، إلا أن الظفر بحليف يحمي الدعوة وحاملها، ويمكّن من الاستقرار في المدينة المنورة، بدّل سلبية الهجرة الحسي إلى أثر معنوي إيجابي، ومن تداعيات الإيجابية عدم تصدي اليهود للرسول، فهم أهل كتاب، ولديهم آيات وعلامات وإرهاصات لظهوره، ما أعلى شأن التعايش عبر المعاهدات البينية، التي تحفظ لكل طرف معتقده، وعاداته وتقاليده، وتضامنت قبائل مع الدعوة المحمدية، لتتحول قريش من حالة الظهور والغلبة إلى حالة استعطاف واسترضاء، وانتخاء بصلة الدم والقُربى، استشعاراً لعلو كعب المسلمين، فتعاملت مكة الجديدة، بمناورات، وبراغماتية، مع الواقع المستجد.
ولا ضير في الاعتراف بارتباك المجتمع المسلم حال بلوغه وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه سرعان ما استعاد تماسكه، باختيار خليفة، وإن لم يكن الخليفة نبيّاً، إلا أن له سلطة دينية، ومكانة اجتماعية، بحكم تزكية القرآن الكريم لهم، ووصية النبي للأمة، بأن يستوصوا بهم خيراً، ومرّ زمن أبوبكر الصديق رضي الله عنه (سريعاً).
وبحكم أن زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه زمن مفصلي، شهد تحولات كبرى، وقرارات إصلاحية جذرية، وقراءة جديدة ومتجددة للنص المُحكم، ناهيكم عن المُتشابه، فلا غرابة أن تتخلق فكرة تأسيس دولة، واستعان بداهيتين، كانا مركز الثقل فيما جرى، وكل ما سيجري (معاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص).
لم تستمر حالة الألفة التي نشأت في سقيفة بني ساعدة، فسرعان ما دبّ الخلاف، وتم تحييد النواة الدينية، واستبدالها بالدنيوية، وادعت بعض الأطراف المظلومية، ووقع الشقاق، والانقسام، ليطال القتل ثلاثةً من الخلفاء، الفاروق، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، رضي الله عنهم، وبرغم أن الفتوحات اتسعت إلا أن النفوس ضاقت، والمشاعر احتشدت، والمسلمين استباحوا ما حَرُم من دماء بعضهم، وحلّ المطمع الدنيوي محلّ الانتماء لقيم الدِّين الذي من آدابه الزهد في الدنيا؛ والإعراض عن المناصب.
ولم يستتب الأمر لمعاوية بن أبي سفيان، إلا عقب نزال محموم، مع علي بن أبي طالب؛ في معركة الجمل بسبب قتلة عثمان، ثم صفّين، وبمجيء معاوية إلى السُّلطة، تأصّلت مركزية الحكم عند بني أميّة، وتأسست أوّل عاصمة للدولة الإسلامية (دمشق) واعتُمدت الدواوين (وزارات) أو مؤسسات الدولة، وامتد النفوذ للسند، والأندلس، وبلاد ما وراء النهرين، واستمر حكم الأمويين قرابة تسعين عاماً، لم تخل من منغصات، تراكمت باستدعاء النواة الدينية، مجدداً.
وعلى أنقاض الدولة الأموية، قامت الدولة العباسية، المنتسبة إلى العباس بن عبدالمطلب، رافعةً الشعار الديني، إلا أن قيامها قائمٌ على محددات ومرتكزات، لا على أحلام القيادات، ولا تمنيات الزعامات، ولا منامات الشفيفون والشفيفات، انتهى العهد الأموي عام 132هـ، وبدأ عصر أحدث، تجلّت فيه المدنية بأبهى صورها، في ظل فتح الحدود على مصاريعها، وانتقال العاصمة من دمشق إلى بغداد، وازدهرت الدولة في عصرها الأول، ولم يفلح العباسيون في صون حكمهم كما يجب عقب مئتي عام، لكثرة الدخلاء، فالسلطات تعددت، والولاءات تشعّبت، فتفككت مركزية الحُكم، ولم يتجاوز نفوذه العراق، بل نازعه السلطة والنفوذ داخله (دول) منهم (البويهيون) و(السلجوقيون) وغدت الدولة في آخر عهدها إقطاعات متعددة بأجنحة وأذرعة وفضاءات.
لا ريب أن الدول الحديثة حققت ما عجزت عنه سابقاتها، بسبب تأطير الجغرافيا، والتخفف من حمولات التاريخ، إضافةً لعناصر ومقومات تتمثل في القوة والمُقدّرات، وقطعاً أن الدول لا تنشأ من خلال أحلام ورؤى الغفوات، كما أنها لا تحتمل استمراء الهفوات، ولا تدوم إن سمحت بنمو بذرة الشقاق والانقسامات، التي حطّمت أقوى الكيانات، إما بجهلها أو تعصبها، والمزايدة على ما أذنت به سوانح المنعطفات، ولم يعزز دور الدول، مثل التجدد والتجديد من داخلها، فمَنْ تجدّد لم يتبدّد، والأفكار تتخشب وتتصلب بالتقادم، وإذا ما أردت تطويع القديم منها انكسر أو تفتت، والواثق من نفسه، يُعلي شأن وطنه، بالعلم والمعرفة، وإعداد القوة اللازمة؛ بشقيها المادي والمعنوي، وقديماً قال أحمد شوقي؛ بالعِلم والمال يبني الناسُ ملكهم، لم يُبن مُلْكٌ على جهلٍ وإقلالِ.







.png)
 11 الشهور منذ
25
11 الشهور منذ
25






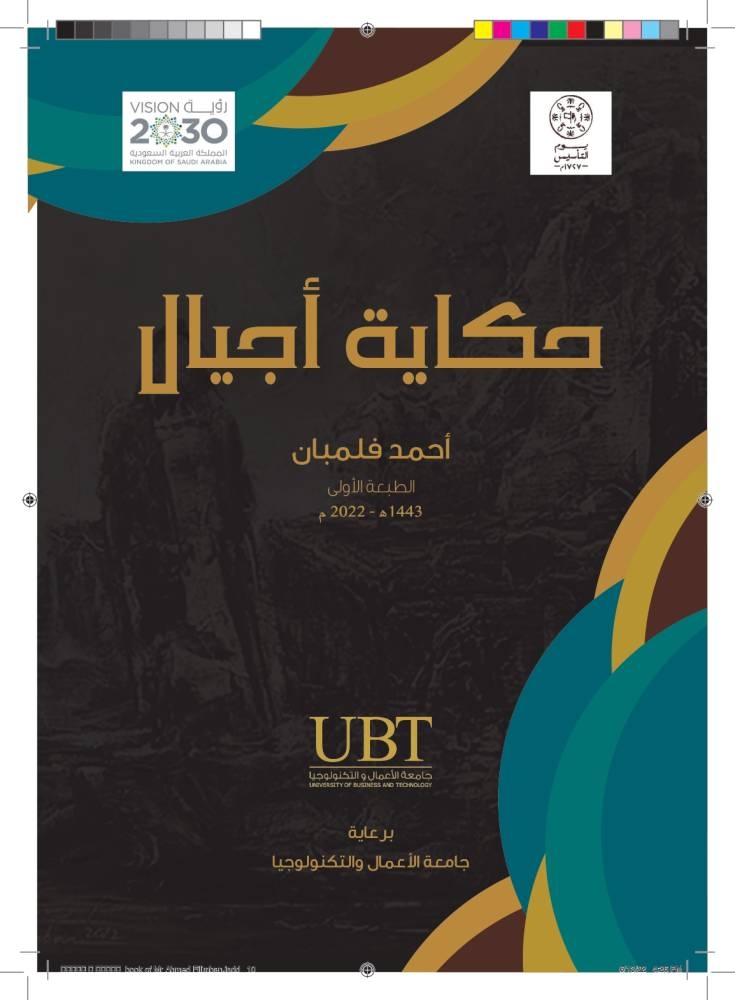

 English (US) ·
English (US) ·