عدّ المفكر المغربي سعيد شبار الثقافة قائدة التغيير ورائدة الإصلاح، كونها «نظرية في السلوك كما هي نظرية في المعرفة» تبني الكيان النظري كما تسدد وتُقَوِّم الممارسة والسلوك العملي.
ويرى أن المكون الديني (الاعتقادي/ الإيماني) داخل الثقافة أهم مكوناتها على الإطلاق؛ سواء وقع التصريح والوعي به، أو لم يقع؛ وسواء حددت وضبطت مجالات التأثير وكيفياته، أو لم تحدد ولم تضبط؛ فكل ذلك ليس بمانع من وقوع هذا التأثير، واضحاً كان أم خفيّا.
وأكد تسليمه بأن الأفكار والنظريات يمكن أن تتحول إلى يقينيات وحتميات يتم الاعتقاد فيها كما يعتقد في الدين؛ بحكم أن الخطاب الإلهي الموجه إلى الإنسان عبر التاريخ، مٌسَدِّد ومُقَوِّم، هادي ومرشد؛ أي مغيرا ومصلحا من زوايا ومداخل متعددة ومختلفة.
وأوضح أن معظم التجارب التغييرية، أو الإصلاحية، التي استبعدت الدِّين كفاعل مؤثر في الإصلاح والتغيير تسترجعه الآن بشكل أو بآخر.. بل إن بعضها بدأ يستغل هذا الدور بشكل بشع أكثر تطرفا وعدوانية؛ من مدخل سياسي يوظف الدين، أو من مدخل ديني منغلق مبني على فهم حرفي ونصي لا يواكب المتغيرات، مشيراً إلى أن المدارس اليسارية بما فيها الأكثر دوغمائية والعلمانية المتشددة والقوميات المختلفة كانت في بداياتها الأولى تبني نظرياتها التغييرية باستبعاد كلي للدين كفاعل أو مؤثر، بل وبمعاداته، وخوض حروب إلغائية وإقصائية ضده، مؤكداً أن هذه الحروب الضروس التي ناهزت قرنا من الزمان، لم تُغَيِّر من واقع الدِّين ودوره في التأثير والتأطير شيئا، بل الذي تَغَير هو توجهات ومقاربات تلك المدارس والتيارات للمسألة الدينية، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أحداثا كبرى غيرت مسار التاريخ والتوازنات في العالم بأسره؛ فالإصلاح في تاريخ الأمة قبل المرحلة الاستعمارية الحديثة، سواء كان علميا أو اجتماعيا أو سياسيا كان منطلقه ومرجعه الأساس الدِّين، وبواكير الإصلاح في العصر الحديث منذ القرن التاسع عشر، كانت كذلك باسم الدِّين والرجوع إليه، قبل أن تبرز تيارات ذات مرجعيات أخرى -معظمها مستعار من التجارب الغربية- إلى ساحة التغيير والإصلاح، وبترسانة مفاهيمية أخرى كالنهضة والتنوير والتحديث والوحدة والتقدم.
وأوضح شبار الفرق بين التنظير القرآني للإصلاح والتغيير وبين التجارب الإصلاحية عبر التاريخ قديمه وحديثه، كونه الفرق نفسه بين الوحي الإلهي وبين الفعل البشري، بين المطلق الحاكم (المعيار) وبين النسبي المحكوم (المعير)، لافتاً إلى أن كثيرا من حركات الإصلاح والتغيير أخطأت موعدها مع الدِّين، ومع سنن ومسالك التغيير التي ينص عليها، وإن تحدثت باسمه ورفعته شعارا وأفكارا. ولهذا كانت مقولة «العودة إلى الدين» دائما على رأس بنود الإصلاح، دون تحديد «كيف» تتم تلك العودة وما هي مداخلها ومراحلها، وأصولها وفروعها، وأولوياتها وارتباطاتها وامتداداتها؛ إذ غالبا ما نجد مشروع «الإصلاح» ينتهي إلى نزال سياسي معين، أو مقاربة جزئية ضيقة، لا تكاد توحد وتؤطر أصحابها فكيف بغيرهم ممن حولهم أو أبعد منهم!
وحذّر من الإقصاء وإلغاء أهمّ مقاصد وغايات الدين وسننه في التغيير، كونه لا يمكن أن ينتهي إلى شيء، إذ ستصطدم بالحقائق الكبرى، وتعود أدراجها إلى الوراء، عقب أن تخلف ضياعا في الوقت، وهدرا في الجهود والطاقات والموارد، وتشويشا على الأفكار والمعارف والعلوم، ما يدفع بدوره للتفتيش عن دورة إصلاحية تصحيحية إضافية.
ويرى أن مشكلة المسلمين كانت في انفصالهم عن دين بنى لهم حضارة، وصنع لهم أمجادا، وجعل منهم ذاتا وكيانا، دين قائم على تمجيد العلم والفكر، والحرية والإبداع، والعدل والإنصاف، والكرامة والكينونة البشرية، مؤكداً أنه منذ وقع الانفصال التدريجي عن قيم الإيمان والعمل بدأ مسلسل الانحدار والانهيار؛ إذ تدعو الضرورة الآن إلى الاتصال من جديد بتلك القيم قصد استئناف البناء والعطاء؛ أي الاتصال بقيم الإيمان والعلم، والعمل والحرية، والفكر والإبداع، والكرامة والمسؤولية.. وكل ما ينشط ويرشد حركة وفعل الإنسان تجاه نفسه وتجاه محيطه.
ولفت إلى أن سنن وقوانين النهوض المتعلقة بالجانب المادي والطبيعي واحدة؛ فمن اشتغل بها وأخذ بها والتزم نظامها رفعته، ومن أخل بها وضعته، فالسنن والقيم لا تحابي مسلما من كافر، ولا مؤمنا من ملحد؛ وقديما نص العلماء على أن الله تعالى ينصر الأمم العادلة الكافرة على الأمم المؤمنة الظالمة، لعدل الأولى ولظلم الثانية طبعا؛ وهل يجتمع إيمان بظلم؟ فهذا الذي ميز عطاء الحضارة الإسلامية الأولى، ويميز عطاء الحضارة الغربية اليوم ويمكنه أن يميز عطاء أي حضارة التزمت المنهجية السننية في البناء.
وذهب إلى أنه لا تكفي السنن الكونية والمادية وحدها في البناء الحضاري والازدهار العمراني، بل لابد من منظومة قيم مرجعية مؤطرة تسدد وترشد حركة الإنسان في فعله وإنجازه. وما دام الإنسان كائنا نسبيا عرضة لمختلف الآفات، كان لازما أن تكون تلك المنظومة من غيره لا من عنده، وليس ثمة من يعلم العلم المطلق بالكون والكائنات إلا خالقها سبحانه وتعالى، ومن هنا ضرورة لزوم قيم الفطرة والدين، إضافة إلى قيم العلم والعمل، إذ كلاهما من مشكاة واحدة، ولا تعارض بينهما، إلا ذاك الذي يفترضه ويختلقه الإنسان في هذه التجربة أو تلك. والذي عبر عنه كثير من العلماء بضرورة ملازمة السنن الدينية الشرعية؛ فمنزل الوحي ومرسل الرسل هو خالق الكون ومسويه ومرتب سننه، ومقدر كل شيء فيه. وأضاف: مهما بلغ الازدهار المادي والإنجاز العلمي والحضاري، إن لم يكن مستجيبا لكينونة وفطرة الإنسان متعددة الأبعاد، مادية ونفسية وروحية.. وملتزما بقيم العدل والإنصاف والحرية والكرامة، فإنه سيبدأ بإفراز مشكلات إنسانية وطبيعية ستكون مؤذنة بخرابه عاجلا أم آجلا. وتساءل: وهل سقطت الحضارة الإسلامية، وهل النخر الموشك على إسقاط الحضارة الغربية إلا من هذا القبيل؟







.png)
 7 الشهور منذ
19
7 الشهور منذ
19






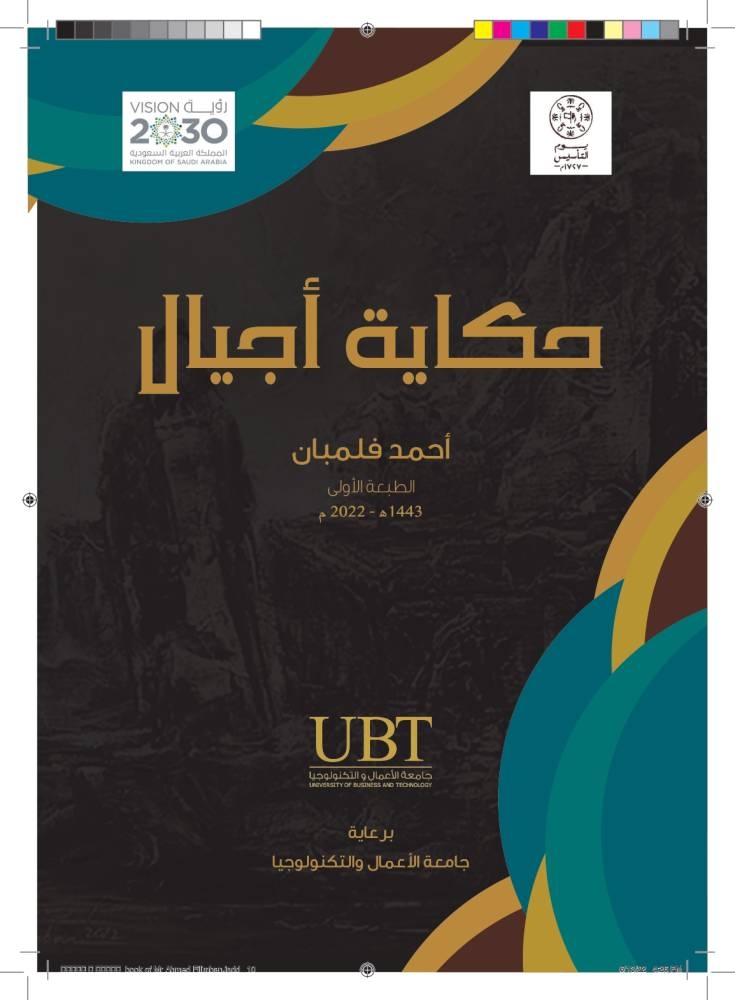

 English (US) ·
English (US) ·