يرى المفكر المغربي الدكتور عبدالسلام بنعبدالعالي، أن الوثوقية ترفض رفضاً باتّاً الشكّ منهجاً، وتتشبث بالحقائق المطلقة معتبرة إياها في غنى عن كل نقد.
واستعاد مقابلها، ففي الفلسفة القديمة قوبلت بالنزعة الشكّية أو البيرونية، أمّا العصور الحديثة فوضعتها مقابلاً للنزعة النقدية؛ وفي الحالتين، كلتاهما طرح المفهوم داخل إشكالية المعرفة، كما ارتبط تحديده بمفهوم الحقيقة والمنهج الموصل إليها.
وأوضح أنّ الإعلاء من الشك منهجاً، ومن النقد أسلوباً، ومن النسبية موقفاً، لم يفرض نفسه إلا مع تطوّر المعارف منهجاً ولغة وموضوعات، مشيراً إلى أن البعض نظر إلى ما يتمخّض اعتناق الفكر الوثوقي من نتائج عملية، ولا يقف عند الوجه المعرفي الصّرف، إلا أنّه كان يقتصر على النّظر إلى الوجه العملي باعتباره مجرد مفعول ونتيجة تترتب عن المعرفة والنظر. وفي هذا الإطار كان يتحدث عمّا يتمخض عن اعتناق الوثوقية من مواقف متشنجة تدفع صاحبها إلى التعصّب لرأي بعينه، ورفض للحوار ومن ثم إلى إلغاء للآخر، بل إلى قمعه وتعنيفه.
وقال: لو أننا حدّدنا الوثوقية منذ البداية، ليس على أنها موقف نظري و«نظرية في المعرفة»، بل على أنها موقف أخلاقي، سياسي بالأساس، لتبيَّن لنا أنّ الوثوقية عنيفة لا بما يصدر عنها من أقوال وأفعال فقط، بل بما تنطوي عليه من آليّة توحيدية ترفض كلّ تعدد للآراء وكلّ اختلاف للمواقف، وتردّد بين شك ويقين. ما يدفعها إلى إدخال كلّ الأمور في دائرتها وإجبارها على الخضوع لمنطقها، مع ما يقتضيه ذلك من آليّة إكراهية.
ويؤكد بنعبدالعالي أن الآلية التوحيدية تمنع الوثوقي من أن يقبل بتعدّد الآراء، وبالأحرى اختلافها. لكن، قبل أن يرفض الوثوقي الاختلاف مع غيره، يبدأ أولاً بالامتناع عن الاختلاف مع نفسه، أو على الأصح بالخضوع لاستحالة الاختلاف مع الذات. قبل أن يسدّ الوثوقي الأبواب على الغير يسدّها على نفسه، وقبل أن يمارس عنفه على الآخرين، يرزح هو نفسه تحت ضغط البداهة وعنفها. فالوثوقي لا يخضع فكره للمنطق، بل إنه يخضع كلّ شيء لمنطقه هو. من هنا ذلك الادّعاء بالإحاطة بكل شاذة وفاذة، إذ إنّ أيّ تحفظ أو تردّد من شأنه أن يحطّ من مكانته ويضعف سلطته وهيبته. من هنا الطابع الكلياني للوثوقية وتوتاليتاريتها.
وعدّ من ظواهرها تسرّع (الوثوقي) في حسم كلّ ما من شأنه أن يفصح عن نقصه وعجزه، نظراً لما يترتب عن ذلك، ليس من إظهار لضعف نظري فحسب، وإنما من تنقيص من صاحب الرأي ومسّ بهيبته وسلطته. فالنقص هنا أيضاً لا يتوقف عند المعرفة والنَّظر، وإنما يطال الهيبة والسّلطة. إذ ليس الأمر مجرَّد جهل بأمور، وإنما هو علامة على قصور وعجز وضعف. لذلك فإنّ ما يميّز الوثوقية هو قدرتها الخارقة على الإفتاء في جميع النوازل مهما كانت طبيعتها ودرجة تعقيدها. فكلّ شكّ أو تردّد لن يكون إلا علامة عجز، وكل خطأ لن يعتبر إلا خطيئة.
وأضاف: وبناءً على ذلك، فالفكر الوثوقي الدوغمائي الذي يسبح في البدهيات واليقين لا يكون، كما يقال عادة، عنيفاً بما يتولد عنه من مفعولات، وما يتمخض عنه من نتائج، وإنما بما هو ينشدّ، أو يشدّ إليه على الأصَّح، وما يعتقده طبيعياً بدَهياً مُسَلَّماً به. فكأنّ العنف هنا عنف بنيوي. وقد سبق لرولان بارط أن بيَّن أنّ البداهة عنف، و«أنّ العنف الحقّ هو أن تقول: طبيعي أن نعتقد هذا الاعتقاد، هذا أمر بدهي»، وعلى هذا النحو، لا يمكن للفكر أن يتحرّر من الوثوقية إلا عندما تنفتح أمامه الأبواب، وتتعدد السّبل، وتتعقد المسالك. آنئذ، إن كانت هناك بداهة فهي لا يمكن أن تكون إلا عند نهاية مسار، وإن كان هناك وصول إلى حقيقة فهي لا يمكن أن تكون إلا تعديلاً لرأي، وتصحيحاً لأخطاء، ويغدو الفكر مرادفاً للنقد.
ولفت إلى أن الوثوقية تمثّل العنف والقمع بما هي بداهات تسدّ أبواب الشك وتوصد سبل النقد فتسجن صاحبها داخل «كلّ موَحَّد»، وتحول بينه وبين أن يتنفس هواء الحريّة، فهي مرتبطة بالتشنج وأحادية الرأي وما يتولد عنها من قمع للآراء المخالفة، وعدم اعتراف بالرأي الآخر، الأمر الذي ربما يؤدي بها إلى عدم الاقتصار على العنف الرمزي، فالوثوقي لا يراجع ذاته ولا يعاود النظر في آرائه، وإنما هناك ما يحول بينه وبين الإصغاء للغير. ذلك أنّ ما يحول بين الوثوقي وبين أن يعاود النظر في ما يعتقد، ليس كونه لا يقتنع بالرأي المخالف، وإنما كونه لا يصغي.







.png)
 7 الشهور منذ
20
7 الشهور منذ
20






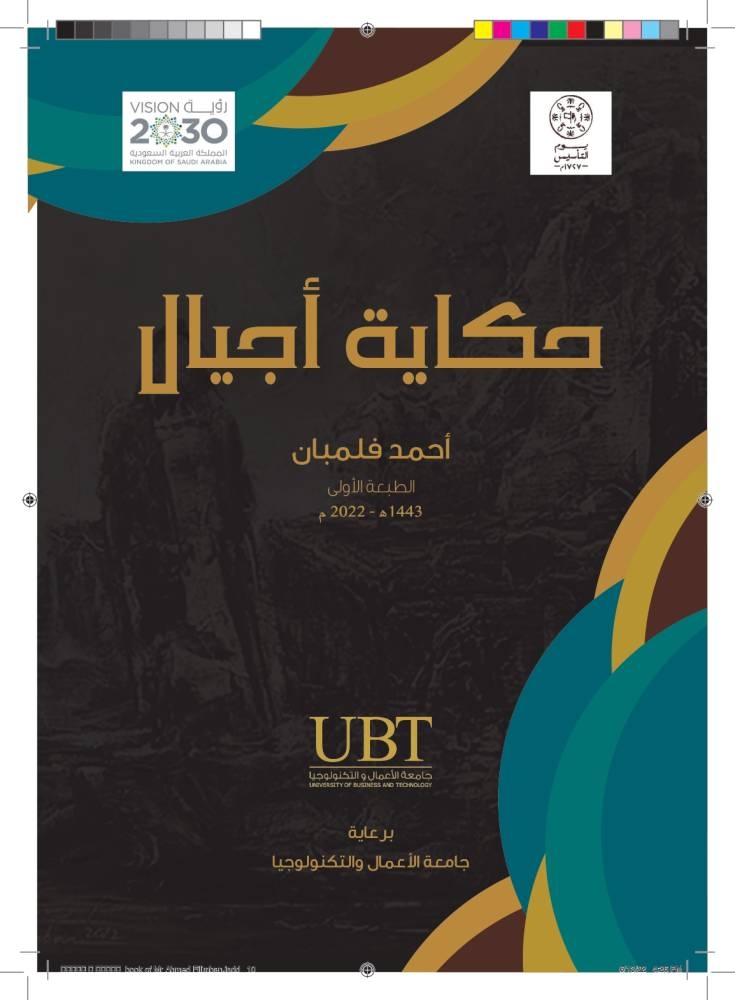

 English (US) ·
English (US) ·