«كنتُ دائماً أحب المطارات.. أحس فيها بطعم الغربة، وعتبات الدهشة الأولى حين أسافر ورائحة الوطن، والأحلام التي تنام على أرصفة الوقت حين أعود.
كنت أحاول دائماً في تلك اللحظات التي تزحف بطيئة فوق الصالات الباردة أن أفك لغتها السرية، التي لا تمنحها للعابرين، وأنا أحتسي آخر فنجان قهوة، وربما ضحكت وأنا أستعيد فيلم
The terminal، حينما وجد «توم هانكس» نفسه مُحاصراً داخل أحد المطارات الأمريكية، لا يستطيع أن يدخل أمريكا ليجمع آخر تذكارات أبيه الراحل، ولا يستطيع أن يعود إلى بلده، الذي وقع فيه انقلاب. فقرر أن يُعيد صياغة ذلك العالم العابر في لحظة عابرة، ليعيش واقعه وعالمه هو.
كانت ولا تزال المطارات مجرد نقطة تسكن روحك، وتتقافز فوق ملابسك وعالم لم يفتح بواباته المطلسمة بعد، أو ربما في وقت ما.. أو حلم ما.. قد منحك جزءاً من عشائه الأخير، على مقاهي المساءات الفارغة، أو في آخر العربات العابرة نحو النهار».
الكلمات السابقة ليست لي بل جزء من مقالة للراحل الكبير الدكتور فؤاد مصطفى عزب الذي كان يكتب هنا (كل أربعاء)؛ بلغته الوارفة و روحه الربيعية وحروفه المغمورة بالندى والحب.
اليوم يمر على رحيله ثلاث سنوات بالتمام والكمال حيث غادر دنيانا الفانية بتاريخ 17 سبتمبر 2021م، ولعلّ أقل ما يستحقه رجل مثله أن نتذكر أثره الجميل وأن ندعو له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته.
لم يكن الدكتور فؤاد كاتباً عابراً، كان طبيباً للقلوب المتعبة و بلسماً للحياة، يزيل الأشواك من طرقاتها ويملأ شرفاتها بالورود والغناء، كان يتفقد أحبته برسائله المترعة حباً صادقاً.. يبعث رسائل الواتساب حتى في أصعب لحظات المرض ليطمئن محبيه على حالته، تأتي حروفه شلال ضياء متدفقاً يمسح كل عتمة ويزرع عبر المسافات حقولاً من النور والتفاؤل قبل أن يختمها باسمه و(مايو كلينك- روتشستر).
غاب فؤاد عزب عن دنيانا لكنّه لم يغب عن ذاكرة كل من عرفه.
قبل وفاته بشهر كتب واصفاً خروجه من المستشفى إلى بيته:
«كانت الدنيا (تزغرد) لي، ازددتُ أنساً وامتلاءً، كانت روحي ذاتها ترقص.
كنت كمن يقرص نفسه، ليتأكد أنه يعيش في الواقع وليس في الخيال.
صوت زوجتي يلمع في المنزل مثل لمع البلور، كانت تعد لي وجبة إفطار بيتوتية، خبز محمص، وزبدة، وقهوة، وعصير برتقال طازج، وبيض مقلي، ممزوج بالزعتر والحبق والطماطم وجبن ريفي.
ما أجمل الصباح عندما يخبرنا أن الأماني مهما تأجلت سيأتي الفجر بها، كانت (Ann Murray) تصدح في أرجاء البيت من مذياع المطبخ، بصوتها المغمس بشقوق الضوء والممتد بكسل أبيض على منحنيات الخشب المشبع بماء المطر:
You gave me strength
To stand alone again
To face the world
وقع الأغنية في أذني كالسحر، إحساس غامض وغريب مغلف بالشجن، اكتساني وأنا أتابع الأغنية. قطار القرية الكهل ما زال يمر بمحاذاة «الميسوري»، يطلق صوته الحزين، مُرحّباً بي.. وتلمع عيناه الأماميتان بهجةً وحبوراً. أيها القطار الكهل العجوز، ما أقوى صخبك، وضعف لياقتك، مثلي.
لقد اشتقت إليك، ولكل الأيام في (بارك فيل). كان لي شعر أسود، وأحلام بلون الثلج، تغير لون شعري، وظلت أشواقي بيضاء. لقد اشتقت أن أفعل أشياء كثيرة، لم أتمكن من فعلها خلال العامين الماضيين. اشتقت أن أمد يدي لأصافح فجراً مليئاً بعصافير تقتات من كفي، وأن أزرع حديقة منزلي بنفسي، وأن أتسوق في سوق الفلاحين، بقميص القطن الأبيض، وأن أعد إفطار زوجتي، وأن أسافر إلى بحيرة (أوزارك) لأعود في المساء، أجر قاربي من أنفه خلفي، وأن أرمي بجسدي على أقرب كرسي هزاز، وأمارس هواياتي المفضلة، في العبث بمحطات التلفزيون.
اشتقت أن أمرّغ رأسي في الثلج، وأن أرقص على الجليد بقدم واحدة.. وأن التهم حبات الكستناء من جوف الجمر مباشرة، وأن أجد الوقت الكافي لأراجع مواقفي كل مواقفي، وأرى العالم بدون كوادر أو حواجز. أفتش عن كل ذلك في نفسي بمنتهي الصدق والحيادية، أن أكوّن نفسي..!»
رحمه الله رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم.







.png)
 2 الشهور منذ
5
2 الشهور منذ
5






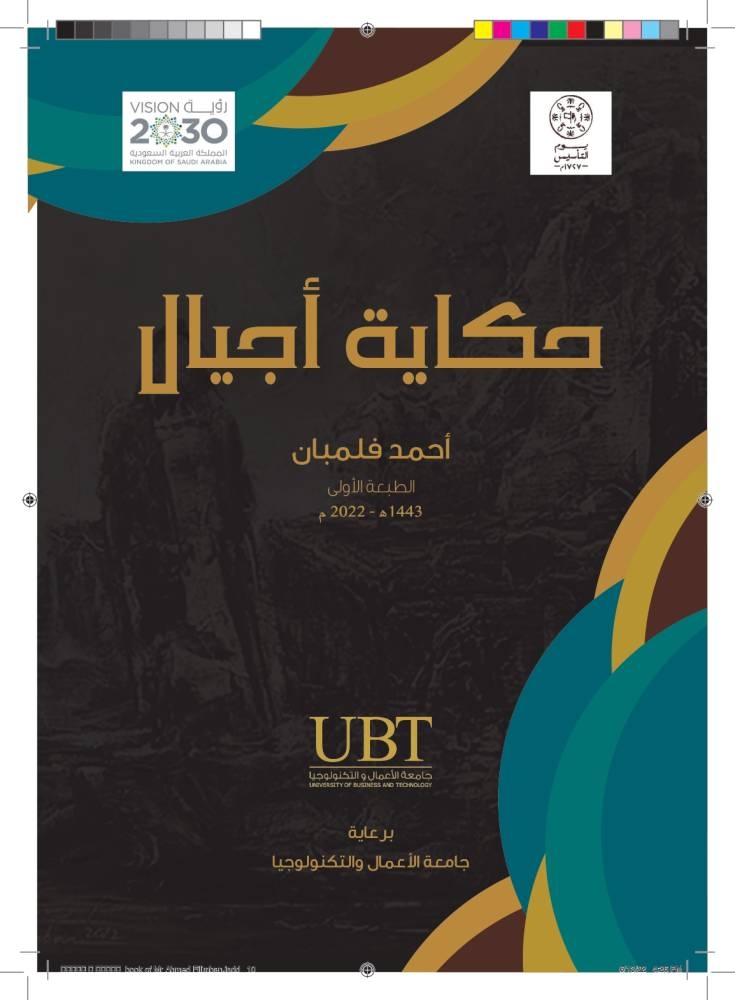

 English (US) ·
English (US) ·