ليت أحداث العقود العربية الثمانية الماضية تعلّم العرب الدرس الذي يبدو أن الغالبية لم تستوعبه بعد، وخلاصته: ضرورة قيام المصلحين العرب -أينما وجدوا- بالعمل على إدخال بلادهم إلى العصر..وعبر الأخذ بوسائل التقدم التي أخذت بها الأمم النابهة، وفي مقدمة ذلك: المؤسساتية السياسية، التي -إن تم تبنيها في الواقع الفعلي، بشكل سليم- تمهد الطريق للنهوض والتقدم السليمين، في كل مجالات الحياة، وتُكسب الآخذين بها القوة الدولية التي تتناسب والإمكانات الفعلية لهم. ولا شك، أن نهضة كهذه ضرورية ليست فقط لمواجهة الكيان الصهيوني الغاصب، بل ولتحقيق حياة كريمة.
ومن ثم يمكن السعي السليم والمدروس، لاحقاً نحو التضامن العربي، وتكوين تكتل عربي قوي ومتماسك، لا يأخذ من الناصرية إلا مبدأ الاتحاد والتضامن.. وهو مبدأ أزلي قديم، لم تفعل الناصرية أكثر من رفعه كشعار، والتذكير به، كضرورة. ويمكن أن يرتبط التكتل العربي المرجو بتحالف استراتيجي مع من يرغب من البلاد الإسلامية.. لتكون للجميع كلمة أقوى (موحدة أو شبه موحدة) مسموعة على الساحتين الإقليمية والعالمية.
****
تلكم أمانٍ، ما زالت أحلاما.. بل إن هذه التطلعات تكاد أن تصبح (الآن، ومع مرور الأيام، وتفاقم الأخطار) في عداد المستحيلات؛ بسبب تدهور الوضع العربي اليومي، وتحوله من سيئ لأسوأ، وازدياد سطوة وشوكة أعداء هذه الأمة، وفي مقدمتهم الكيان الصهيوني الغاصب، وداعموه. لقد تراجعت الطموحات العربية اليوم، وتواضعت كثيرًا.. بعد أن عز، في كثير من ديار العرب، حتى الأمن والبقاء...؟!
إذ نرى، في الوقت الحاضر، أكثر من ثلث عدد الدول العربية (ثمان من اثنين وعشرين) كدول «فاشلة»، ومضطربة، أمنياً وسياسياً. كما نرى في الأفق احتمال «تزايد» هذا العدد، بسبب تمكن التحالف الصهيوني – الاستعماري، الموسوم (صراحةً وضمناً) بالإرهاب والتطرُّف ودعم الاستبداد والطائفية والمذهبية، وهو يقوى، ويوشك على تحقيق أولى خطوات مشروعه الكبير ضد العروبة والإسلام.. هذا المشروع الذي يتجسد في: استتباب إسرائيل كقوة إقليمية عظمى ضاربة تهيمن على كل المنطقة بعد أن تقسم معظم بلادها، ويمعن في إضعافها، وإحالتها إلى دويلات منهكة مستضعفة، لا حول لها ولا قوة... تأتمر -أو يأتمر أغلبها- بأوامر وتوجيهات تل أبيب، وواشنطن.
****
ولنقف هنا، لمراجعة كيف سيحصل هذا السيناريو الرهيب، وعبر كيان مصطنع، لا أساس له من صحة التواجد، غير القوة والدعم الغربي الاستعماري؟! إن قوة الغرب الإمبريالي هي التي تقف كداعم مخلص للمشروع الصهيوني، أما الكيان الصهيوني نفسه، فليس له أي أساس شرعي، يعتمد في وجوده عليه. وبعد خمس وسبعين عاماً من تواجد هذا الكيان السرطاني في قلب الأمة العربية، أمست غالبية الشعوب العربية على وعي بحقيقة هذه الدويلة، التي لم تخلق لدى هذه الغالبية سوى الامتعاض، والغضب، والكراهية المطلقة، لسياساتها التوسعية العدوانية. قلة قليلة تافهة من المتصهينين هي التي تنظر لإسرائيل كدولة عادية «محترمة». ويبدو أن المتصهينين لم يصبحوا كذلك إلا بتوفر صفة أو أكثر من تلك الصفات الأربع الشهيرة فيهم؛ ألا وهي: إما مستفيد من إسرائيل، بشكل أو آخر، أو فاسد المشاعر والأحاسيس الإنسانية، أو جاهل بطبيعة وحقيقة وتاريخ الكيان الصهيوني، أو منافق يتملق لأنصار إسرائيل، وداعمي عدوانها، وخاصة أمريكا، باعتبار أن «الطريق إلى قلب أمريكا يمر عبر إسرائيل». أما الإنسان السوي، وخاصة العربي، فإنه لا يمكن أن يقبل بإسرائيل، كما هي عليه الآن. فهذا القبول لا يعني سوى عمى البصيرة، وخيانة الذات.
****
هناك أكثر من عشرين سبباً منطقياً وجيهاً، تثبت- بالتأكيد- أن «قبول» إسرائيل، كما هي عليه الآن، وعدم الضغط لإرغامها على إيفاء «متطلبات» السلام، الذي يحقق الحد الأدنى من الحقوق المشروعة للفلسطينيين، يعني: تطبيعاً مجانياً غبياً ومقيتاً؛ وهذا التطبيع المذل والمهين له تداعيات ونتائج سلبية مروعة، ومرعبة بالنسبة للعرب، وللمطبعين منهم بخاصة. ولنلخص ثلث هذه الأسباب فقط، فيما يلي:
(1) خذلان الشعب الفلسطيني، وعدم إنصافه، وتكريس الظلم الفادح الذي أنزل به. وبالتالي، المساهمة في تفاقم هذه المأساة العربية والإنسانية الكبرى.
(2) أن صلة يهود (السفرديم)، وهم يهود الشرق، بفلسطين، لا تبرر إطلاقاً اغتصابهم لفلسطين. أما صلة اليهود (الأشكناز)، وهم يهود الغرب، بالمنطقة، فتكاد أن تكون معدومة، ناهيك أن تكون لهم صلة تذكر بأرض فلسطين. وما جاء في بعض الكتب السماوية عن هذه الصلة إنما خص به يهود ذلك الزمان فقط. وليتنا نرجع إلى بعض مؤلفات المؤرخين الموضوعيين، لنعي هذه الحقائق جيداً، ولا نركن للروايات الصهيونية في هذا الشأن.
(3) قيام الدولة الفلسطينية المستقلة يوقف الأحلام الصهيونية المسعورة، ويقف حجر عثرة في طريق السياسات التوسعية الإسرائيلية؛ فالسبيل الوحيدة لاكتفاء شرور إسرائيل هذه هو زوالها (المحتمل) أو احتواؤها داخل حدود 1967م.
(4) أن الحركة الصهيونية لا تستهدف فلسطين وحسب، بل كل العرب والمسلمين؛ فهي تسعى لإقامة «إسرائيل الكبرى» (من النيل للفرات) على أشلاء الوطن العربي...! وهل تمتلك إسرائيل هذه الترسانة الضخمة من الأسـلحة التقليدية والاستراتيجية لمواجهة الفلسطينيين؟!
(5) هذا الكيان السرطاني يعتبر (أو يجب أن يعتبر) ألد أعداء الأمة العربية والإسلامية، ولا يوجد في العالم من هو أشد عداوة للعروبة من إسرائيل.. فكيف يؤمن العرب جانبها، وتُفتح لها الأبواب العربية على مصراعيها؟!
(6) أن معظم ما يجري بالمنطقة العربية من اضطرابات وقلاقل، بل وجرائم، ومجازر، وما يجري بفلسطين من حروب إبادة جماعية، تقوم إسرائيل واستخباراتها بارتكابه. فهذا الكيان يستمتع بمآسي العرب، ويسعى، على مدار الساعة لزيادة جراحهم.
(7) على الرغم مما يشاع ويقال عن (التقدم) التقني والصناعي الذي تتمتع به إسرائيل الآن، إلا أن معظم ما يقال هو محض هراء؛ فهذه الدويلة العنصرية ما زالت تعيش على الهبات والإعانات الأمريكية والغربية الضخمة. وأغلب ما يمكن أن يرجوه العرب من إسرائيل يمكن الحصول عليه من دول أخرى، وربما بتكلفة أقل، وشروط أفضل.
(8) إن إسرائيل هي التي ترفض السلام، بصيغته المجمع عليها عالمياً، ولا تقبل بـ(التعايش) السلمي، فهي تريد أن تكون القوة الآمرة الناهية في المنطقة، بعد العمل على تجزئة وتمزيق ما حولها من كيانات عربية.
****
نشر مركز أبحاث الجينات بجامعة جون هوبكنز الأمريكية الشهيرة مؤخراً، بحثاً علمياً، نشرت أهم استنتاجاته، على نطاق عالمي واسع، في شهر مارس 2024م؛ ومفادها أن بحوث الـDNA، أثبتت أن 97.5% من اليهود الذين يعيشون في إسرائيل الآن، ليس لهم أصول عبرية إطلاقاً، وغير ساميين...؟! وأيضاً ليس لهم أي صلة تاريخية في أرض فلسطين، بينما 80% من الفلسطينيين، الذين يعيشون الآن بـ(إسرائيل)، أثبت فحص الـDNA أنهم هم الساميون الأصليون...؟! ألا يكفي استنتاج هذا البحث، وحده، لنسف«الأساس الأكبر»، الذي تبرر الصهيونية على أساسه قيام ونمو وتوسع كيانها الغاصب...؟!







.png)
 6 الشهور منذ
6
6 الشهور منذ
6






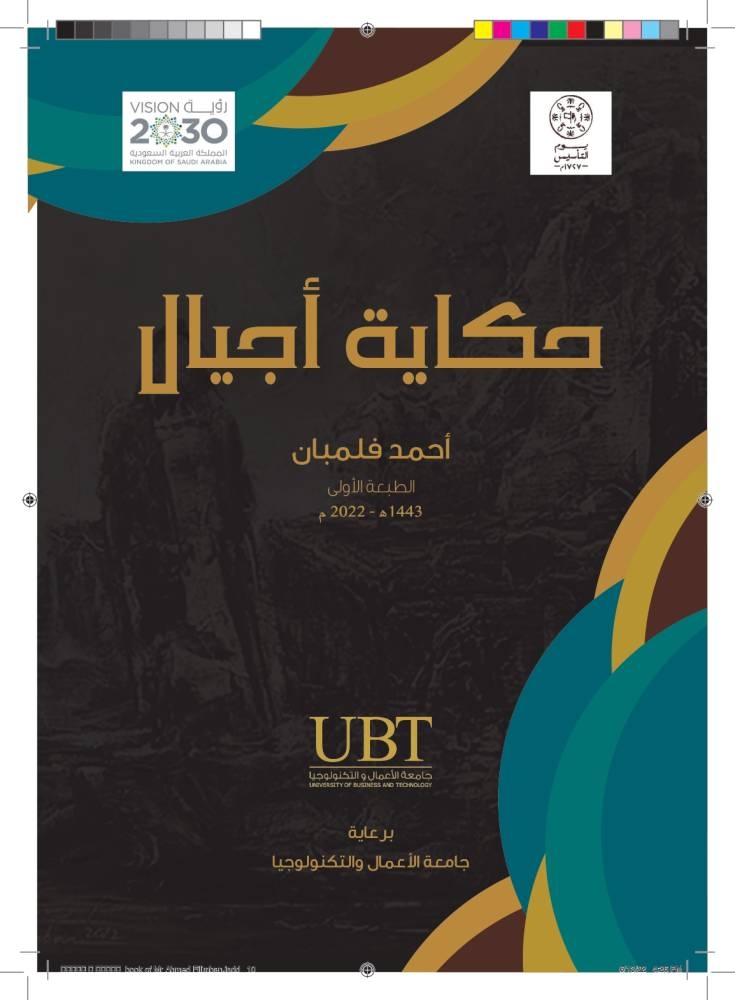

 English (US) ·
English (US) ·