تثير قضية إنجاز الفعل الثقافي والأدبي والإداري، الجدل بحكم غلبة الذاتية لدى البعض؛ حدّ نسبة المنجز المؤسسي لنفسه، دون حفظ حق السابقين له، ولا استشعار لدور اللاحقين، وربما لشدة حساسية مواقف البعض في حفظ حق المبدع والفنان والمثقف؛ تضيع جهود الجميع، بين (أنا) متضخمة من جهة، ونكران وجحود من جهة مقابلة؛ ما يُشعر الراصد والمتابع بأن المنجزات يتيمة، أو فاقدة أحد أبويها؛ وفيما استشعر مشاركون خطورة الجحود وتداعياتها الموجعة.. طالب آخرون بميثاق شرف يحمي من تضييع الحقوق والجهود أو إنكارها؛ وهنا استظهار لرأي نخبة معنية بتوثيق المراحل والمنجزات، إذ عدّ الكاتب المسرحي محمد ربيع الغامدي الإشارة إلى الجهود السابقة، ووصفها بدقة وبكل تفاصيلها، وبيان ما أضافت وما غاب عنها من الناحية العملية، جزء من كمال البحث العلمي، ويتعين على الباحث أن يعقد فصلاً في بحثه عن الدراسات السابقة فيصبح ذلك الفصل جزءاً مهماً من أجزاء الإطار النظري للبحث، لا تستقيم الأطروحة إلا به.
وأضاف، وبعيداً عن البحث والدراسة، فإنه من كمال شخصية العالِم أن يشير إلى السابقين له في تلك المهمة، ليعرف السامع حجم الجهد ومساحة الاطلاع التي يتحلى بها هذا العالِم، كون تعريفه بجهود السابقين شهادة له على جودة جهده هو.
ويؤكد ابن ربيع؛ انطلاقاً من منطق الواقع المعرفي، أنه ليست هناك معرفة يتيمة الأب والأم، فالمعارف بناء تراكمي، والمنقطعة منها تظل معزولة عن التطبيق إلى أن تجد لها ما يؤيد جهود السابقين، ويرى أن حفظ الجهود السابقة قيمة علمية عليا، بغض النظر عن أي قيمة أخلاقية، مشيراً إلى أن النفوس الطاهرة تأبى أن تهمل جهداً سابقاً، لأن حفظ الجهود السابقة خُلق كريم، وشيمة من شيم النفوس التي تسعى للكمال، وصدق الرسول الذي قال: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق».
وذهب الناقد الأكاديمي الدكتور أحمد التيهاني، إلى أنه لا كُفْر يشبه الجحود؛ كونه دناءة في ذاته بوصفه إنكاراً وتنصلاً ومناقضاً لشيمتي (الوفاء، والشكر)، وعدّ التنكر إيذاءً بوصفه فعلاً ذا أثرٍ يتعدى إلى (المجحود) بالإيلام، فلا يتوقف عند الفعل نفسه، وإنما يمتد إلى المجحود بوصفه مظلوماً ظلماً مضاعفاً؛ لأنه -بطبيعته البشرية- يتشوف الوفاء والإنصاف والتكريم والشكر، ليُصدم -في الوقت الذي يتوقعهما- بالجحود والنكران، وهما نقيضا المروءات والشيم التي دأب العربي على الفخر بها، فيما يتخلى الجاحد عنها عامداً، لأنه (براجماتي)، أو (نذل) أو (قليل خير)، أو (عديم تربية).
ونعت التيهاني الجاحد بالنذل واللئيم بامتياز، فالعرب تقول: «عادة الكرام الجود، وعادة اللئام الجحود»، ولفظة: (اللؤم) رفيقة رقيقة عندما يوصف بها الجاحد؛ لأن فعله مناقض لأيسر (الأخلاقيات)، فضلاً عن أن الوفاء، لا يحتاج إلى جهد كبير، بقدر حاجته إلى إنسانٍ سوي، لا يشعر بنقص، أو يستمع إلى الوشاة الذين يريدون به الشر، قبل أن يريدوه لمن يشون به عنده. وصنّف الجاحد إلى جاحد بذاته، وجاحد (بالنيابة) عدّه؛ أسوأ الجاحدين، لأنه جاحد مُسيّر، أو جاحد (إمّعة)، يتّبع الناسَ في الإساءة دون أن يتّبعهم في الإحسان، فضلاً عن أنه ليس ذا قرار، أو رأي، أو استقلال، أو قدرة على التمييز.
ويرى أن من أقبح أشكال النكران والجحود، ما يصدر عن المثقفين، وأخص منهم العاملين في الإدارة الثقافية، وهؤلاء فريقان: جاحدون عمداً فطرة، يعلمون فضل السابقين ويعرفونه، إلا أنهم ينكرونه لضعفهم، ولأنهم يتوهمون أن السابقين سيسحبون البساط من تحت أقدامهم.
وآخرون: جاحدون بالجهل، وهم الذين قفزوا -مع التحولات السريعة- إلى قيادة العمل الثقافي دون خبرات وتدرج طبيعي، فجحدوا السابقين لأنهم لا يعرفون أصلاً، ولا يدركون شيئاً سوى أنهم أصبحوا قادة العمل الثقافي فجأة، فراحوا يؤسسون متناسين الأسس الأولى، وما هكذا يكون العمل! وأضاف وأبشع الجحود وأقساه جحود الفعل الذي يهدف منه صاحبه إلى مصلحة الجمْع -أهلاً ووطناً- لا مصلحة الفرد؛ ذلك أن الفاعل من أجل الجمْع، يتفانى ويضحي ويصارع ويعاني، وربما يتأذى؛ لذا يكون الوفاء معه (بلسماً)، ويكون جحود فعله شبيهاً بإعادة آلام معاناته، وجراح صراعاته، إلى قطرتها النازفة الأولى، ما يجعل جحود الفعل العام الذي لا يهدف فاعله إلى كسب، أو مصالح ذاتية، جحوداً في الدرك الأسفل من الجحود، وبالتالي يكون ناكرو الفعل من أجل الجمع، في الدرك الأسفل من (اللا إنسانية). وزاد التيهاني: وأسوأ مِن أسوأ الجحود، أن يرافقه أذى متعمد، إذ لا يضيفه إلى (النكران)، سوى أحد ثلاثة أشخاص، أو إحدى ثلاث فئات: فئه المُغرر بهم، من الذين يجحدون ويؤذون، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعاً، ويقيمون معوجاً: ومتحينون، أو متسلقون، يظنون أن جحود الآخرين، وأذاهم، طريقهم الوحيدة نحو تحقيق ذواتهم وأهدافهم، وهم -على الدوام- يدركون أنهم عاجزون عن تحقيقها بقدراتهم الضعيفة، فيلجأون إلى صناعة أسباب جحود سابقيهم، من أجل (الإحلال)، أو (الاحتلال)، وذلك وهمٌ عظيم؛ لأنه لا بقاء ولا نجاح -في حالات (الصلاح العامة)، وسيادة العدالة- إلا للأقدر والأصلح: والمصابون بداء الانتماءات الضيقة، ممن يهمهم جحود فعل غير المحبوسين في (ضيقهم الانتمائي)، لتستتر أفعال غيرهم، وتظهر أفعال المنتمين إلى دوائرهم الصغيرة! ويؤكد أن أقسى الجحود على الإطلاق، ذاك الصادر عن مجتمع كامل. وما أكثره، مستعيداً ما جاء في (لسان العرب): «.. والجَحْدُ والجُحْدُ، بالضم، والجحود: قلة الخير».
وعليه، فالجاحد ذو خير قليل، ونصيبه من (الحسنات) و(الشيم) و(المروءات)، قليل.. قليل، ونستعيذ بالله من الجحود؛ لئلا نكون سبباً في دمعة (مجحود)، أو (غبْنه)، أو (قهره).
فيما استعادت أستاذ اللغويات والتأليف والكتابة الإبداعية بأكاديمية الفنون الدكتورة إلهام سيف الدولة حمدان، الحكمة الفرعونية: «الشجرة التي تستظل بها.. زرعها من عاش قبلك، فرُد الجميل بزراعة شجرة أخرى يستظل بها من يأتي بعدك». واستحضرت الحكمة الصينية: «إذا أردت عاماً من الرخاء والثراء، ازرع حبوباً، إذا أردت عشر سنوات من الرخاء ازرع أشجاراً، إذا أردت مئات السنوات من الرخاء ازرع أُناساً».
وعدتها من خلاصة حكمة الشعوب التي شيدت الحضارات على ظهر الأرض؛ وحصيلة تجاربها على مرالعصور، وإن كانت كلمات ربما تبدو بسيطة؛ إلا أنها عميقة المغزى والهدف، كونها تسمو بالإنسان لإيمانها بأنه خليفة الله في الآرض من أجل عمرانها بالعلم والعقل السديد.
الثقافة والفكر.. كالبنيان.. طوبة فوق طوبة.. لا يمكن إنكار من وضعوا أساس العمارة!
وترى أن المتابع لسيرة ومسيرة نجاح علماء مصر في التأسيس العلمي على من سبقوهم في محالهم.. نجد في سيرة ومسيرة العالم الجليل الراحل الدكتور أحمد زويل؛ خير دليل على اتكاء العلماء على ما توصل إليه السابقون في عالم اكتشاف (الليزر)؛ فقام (زويل) بابتكار نظام تصوير سريع للغاية؛ يعمل باستخدام ليزر له القدرة على رصد حركة الجزيئات عند نشوئها؛ وعند التحام بعضها ببعض؛ والوحدة الزمنية التي تلتقط فيها الصورة هي (فيمتو ثانية)؛ وهي جزء من مليون مليار جزء من الثانية؛ وبهذا الاكتشاف تم تصنيفه أحد العباقرة العرب؛ الذي استطاع خدمة البشرية كلها بهذا الاختراع؛ واستحق على إثره جائزة نوبل في الكيمياء.
وأكدت أن البنيان العالي لايستقيم إلا بالأساس الصلد في مواجهة التقدم العلمي فائق القدرة والنمو المتواصل، وعن الدور الواجب لحفظ جهود السابقين في حقول الثقافة والأدب، ثمَّنت سيف الدولة دور الجامعات -في مصر والدول العربية- في تأكيدها على ضرورة التشبث والحفاظ على الهوية الثقافية لطلابها في ضوء المتغيرات المتسارعة المعاصرة؛ خصوصاً فيما يتصل بمسألة (الهويَّة)؛ كونها أخطر وأهم ما يتوقع من خلاله جنوح (البعض) إلى تقمُّص شخصيات خارجية لاتمُت لواقعنا العربي في شيء! وعدت الهويَّة أبرز السمات المميزة للمجتمعات العربية؛ وبالتمسك بها فإننا نُعلي من المبادئ والقيم التي تدفع الإنسان العربي إلى تحقيق كل الغايات والأهداف المرجوَّة للخريطة العربية.
سهولة اكتشاف السرقات
وذهب الناقد الدكتور فارس خضر، إلى أن من مبادئ البحث العلمي أن يبدأ الباحث من حيث انتهى الآخرون، دون إغفال الإشارات المرجعية الدقيقة لجهود السابقين، وأضاف أما في عوالم الثقافة والأدب، فالأمر أكثر دقة وصرامة، ويندر أن يتنكر أديب لجهود من سبقوه، وذلك لأن المنتج الأدبي متاح ومتوفر، ويسهل على القارئ اكتشاف أية سرقة أو اقتباس جائر، أو حتى تأثر يجور على أرض أديب آخر. ودعا خضر المثقفين والأدباء إلى الارتباط بميثاق شرف غير معلن، يُجرّم كل ما يتنافى مع قيم الخير والحق والجمال. وأضاف: «لا ينبغي نسيان أن لكل قاعدة بعض الاستثناءات الصارخة.. ومن السذاجة أن نتصور أن من يؤلف أو يقرأ كتاباً يملك من الأخلاق والوعي ما يجعلنا نحترمه، ونتعامل معه بوصفه إنساناً نبيلاً؛ مستعيداً». مقولة (جان جاك روسو) «المعرفة لا تولد الأخلاق، والأفراد المثقفون ليسوا بالضرورة أناسا صالحين»، مؤكداً أن
الرهان دوماً على قدرة جمهور القراء، وذاكرتهم القرائية، على الفرز والمقارنة، كي لا تنكسر القاعدة الأخلاقية، ولا يقع إهدار حقوق السابقين الأدبية وغيرها. وعدّ وسائل الحفظ الحديثة والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها آليات حافظت على حقوق الأدباء، وجعلت من العسير أن ينجو سارق أو مستلب دون مساءلة أو عقاب.
فيما أكد مدير فرع جمعية الثقافة والفنون في الباحة علي خميس البيضاني، أن قيمة المنجز بتراكمية التجربة، وبتعدد بصمات المشاركين في الإنجاز، مشيراً إلى أن قدرات البشر ليست على مستوى واحد، وظروف كل زمن ومرحلة ليست ذات الظروف، ما يحتّم حفظ أي إسهام في أي مشروع ولو بفكرة أو كلمة، مثمناً جهود دارة الملك عبدالعزيز والمكتبات الوطنية، والصحافة الثقافية التي تعنى بالتوثيق؛ ولا تتجاهل أي دور مهما كان محدوداً كوننا باعترافنا بفضل الآخرين نشجع من يأتي بعدنا على الاعتراف بفضلنا.







.png)
 11 الشهور منذ
24
11 الشهور منذ
24






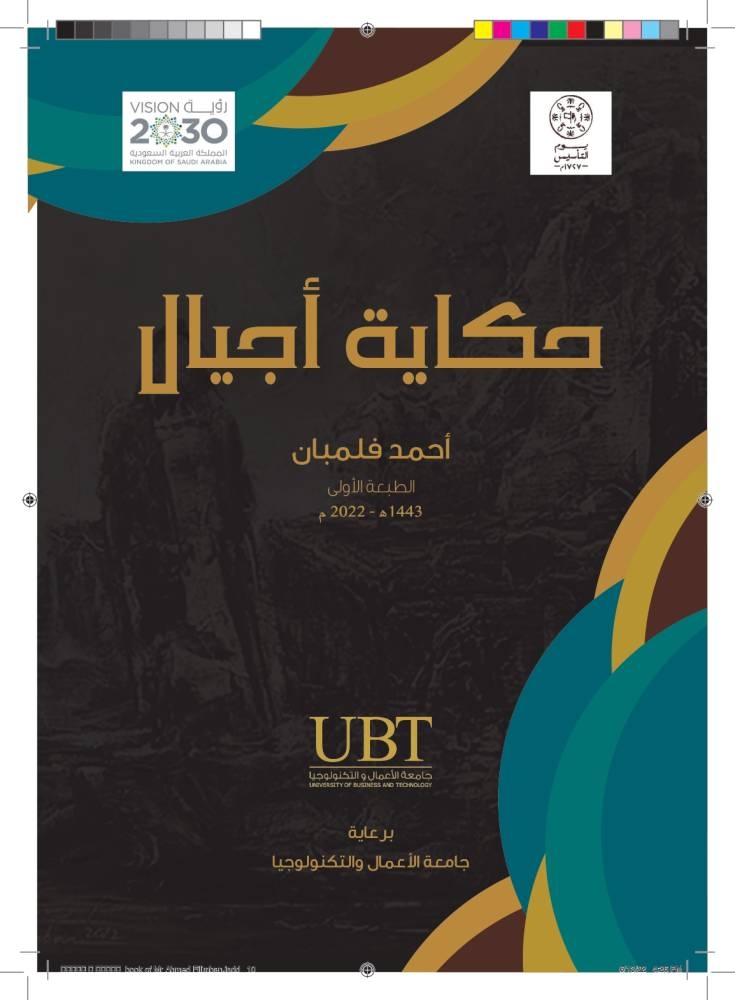

 English (US) ·
English (US) ·