«لم أكن ذا خيالٍ وقلبٍ جريئينِ
كي أتخلَّصَ من خجلي المتربِّصِ بي
ثمَّ أروي لكم ما سأروي لكم عن حقيقةِ ما عشتُ...»
القراءة تجعل سعادتي ممكنة على الرغم من التهديد المستمر من كلِّ ما حولي، إلا أنَّ ذلك لا يمنع استعدادي للسعادة. والقراءة كانت شعرًا هذه المرة، وعلى الرغم من أنني لستُ من هواة الشعر، وأعتقد كما الكثيرين غيري أنَّ هناك الغث الهائل الذي يطوف حولنا كدوامة إعصار، ربما بسبب الإسفاف بالكلمات التي يُجيزون تسميتها «شعرًا»، وهكذا لم يعد هناك متسع لقارئ لأنَّ جميع المقاعد محجوزة للشعراء والشاعرات...
لكن ثمة من يقدِّم لنا الكلمة بشكلٍ جارح ومجروح يطمح إلى الوضوح والمواربة في كلِّ كلمة، لكنَّه مغموسٌ في زحمة تلك الآلام الكبيرة، وهذا ما شعرتُ به حين قرأتُ للشاعر الفلسطيني نمر سعدي ديوان (وصايا العاشق) وديوان (نساء يرتِّبن فوضى النهار)..
ديوان (وصايا العاشق) جميل ورقيق جداً وغنيٌّ بالصور الشفافة، ولا يمكنني إخفاء افتتناني بمقتطفات كتبتها على الهوامش فورًا:
«يمرُّ بي شخصٌ غريبُ الحزنِ يقضم نجمةً فمُهُ»
«كنتُ ألمع النمشَ الخفيفَ النرجسيَّ»
«اعطني سبباً لأعرفَ
أنَّ ما أنا فيهِ ليسَ من التقمُّصِ
واعطني قلباً لكي أنسى
وأذهبَ في طريقِ البحرِ»
على الرغم من اختيار عنوان قصيدة (وصايا العاشق) عنواناً للديوان، إلا أنني كنتُ أفضِّل لو وقع الاختيار على (مزامير لحبق أيلول) لجمالها وتنوُّعها. ومع قصيدة (صمت) ستجد نفسك تصمت، وتمنح الهدوء بعض الرَّقة. وتسأل في قصيدة (من أنت) عن الفاعل المرهف، من أنت؟
أعتقد أنَّ هناك من تحدث عن ديوان (وصايا العاشق) خيرًا مني، ولن أكمل أو أضيف، لكن سأكتب ما شعرتُ به وفكرتُ فيه، فإضافةً للغة الرقيقة، هناك البعد عن الجموح بالصور الشعريَّة وهذا رائع جداً حتى لو كنَّا من فلسطين فالكلمة تكفي.. والأمر الآخر الجميل هو مزجُ الأساطير بالقصائد حيث لا تجد فيها تبجُّحًا أو إثقالًا للنص، بل بعض التمجيد والتذكير بسحر الأساطير وأبطالها وكل ذلك في سياق منساب منسجم.
كنتُ أسترق في كلِّ يوم بضع هنيهات للقراءة وإعادة القراءة، وكتابة ما يعجبني، قرأتُ أشعارًا ذات شذىً كشذى النباتات البريَّة، تأسرك بنبرات مقاطعها، وتنبئ عن شيء خبيء، وتعدك بالسكون تحت حفيف شجرة مزهرة، كثوب إلهةٍ، وربما كسقف الجليل...
«كُلُّ من كنتُ حدَّثتهُ عن صبايا الجليلِ ولم يكترثْ
لأنوثتهنَّ التي تترقرقُ كالأغنياتْ
كانَ يحيا بعينينِ مشدودتينِ إلى هُوَّةٍ
وبقلبٍ بلا حبقٍ طائشٍ وبلا ذكرياتْ»
هناك في فلسطين ينمو الليمون ويكثرُ الشعر، ولا أعرفُ إن كنتُ قرأتُ بعضه أم أقلَّ بقليل، حتَّى في قصائدهم تشعر وكأنَّ لديهم بيتًا يمكثُ هناك في مكان ما من غير إتمام، ولكنَّهم يواصلون الحديث عن إكمال بنائه، وإشاعة الحياة والحبَّ وزهور اللوز والنبيذ في حناياه.
«شوارعُ حيفايَ موحشةٌ بعدَ منتصفِ الليلِ
صامتةٌ..
وأنا لا أريدْ
أن أسافرَ وحدي إلى البيتِ منها بقلبٍ شريدْ
وحزنِ نبيٍّ
وعينينِ في روحِ عصفورتينِ
تضيئانِ ما لا يُضاءُ من البحرِ والليلِ..
أو بخريفٍ بعيدْ
ليلُ حيفا نهارٌ لهُ قمرٌ سابحٌ في الوريدْ»
كنتُ أتساءل هل يثق الشاعر بالوحي والإلهام؟ أم يترك الوعي يقوده عبر السبل الصغيرة خطوة خطوة؟ هل يتردد والكلمات تدور أمامه تعابثه بشقاوة متمرسة، ولكنَّه يصرُّ أن يخلع عليها ثوب العفويَّة؟ ليعود بعدها ويغرق التفكير بالأفكار العظيمة كي يتردد، ويتعلم التواضع بالكلمات.
«أعدُّ مسوَّدةً تلو أخرى
إلى الرقمِ الألفِ
ثمَّ أقولُ:
لمن كلُّ هذا الكلامِ الغريبِ عن الحبِّ؟
من خطَّ كلَّ الوصايا؟
أنا؟
أم تُراهُ صدى عاشقٍ يتقمَّصني؟
فأنا هامشيٌّ ولا أكتبُ الشِعرَ...
لا أكتبُ الشِعرَ..
لا وقتَ لي كي أحبَّ..
ولا صبرَ عندي
لأسألَ نفسي ولا كيْ أُجيبْ
طلعتُ كزنبقةٍ حيَّةٍ من رمادِ الحروبْ»
كم شعرتُ بجمال الصور، وخاصة صور النساء، في ديوان (نساء يرتِّبن فوضى النهار)! وأعتقد أنهن يرتِّبن فوضى العالم وليس فوضى النهار فقط، لذلك فهن عاديات، لكن ما إن تلمحهن مرة واحدة حتَّى تعلق تلك الصورة في ذاكرتك إلى الأبد.
الصبايا كبرنَ
البناتُ الصغيراتُ من كنَّ مثلَ العصافيرِ في الأمسِ صرنَ نساءً
قبائلَ من فضَّةٍ وينابيعَ، أشجارَ دفلى، حدائقَ ضوءٍ
نوافيرَ من زنبقِ الليلِ، أو أُغنياتٍ عن القمحِ والحُبِّ والاشتهاءِ
الصغيراتُ صرنَ عرائسَ...
وأسأل نفسي: لماذا يميل بعض الشعراء إلى فجاجة الصورة والمفردة؟ لماذا يفضلون الصور الحسيَّة المغرقة في (الإثارة)؟ هل يعتقدون أنّ رغباتنا تزداد اشتعالًا؟ لا أملك أجوبة، بل أجدني أصمت، وأرغب بشيء من النسيان.
لا أُصدِّقُ الشعراءَ المكتهلينَ كأشجارِ الخريفِ
المتجهمِّينَ كالتماثيلِ الكالحةِ
الذين يمضغونَ نفسَ الكلامِ
المؤدِّي إلى المساربِ الخلفيَّةِ لهبوبِ النحلِ
كنوعٍ من اللبانِ الرخيصِ
لا أُصدِّقُ حبرَ الأُنوثةِ السريَّ
ولا الشاعراتِ اللواتي يُجدنَ اجترارَ القصائدِ العذريَّةِ
عن وشمِ حُزمةِ السنابلِ على ربلةِ ساقِ المرأةِ / النخلةِ
وعن فاكهةِ أجسادهنَّ المحرَّمةِ
لا أحد يعرف شيئًا عن المعنى الذي تمنحه قراءة الأثر الأدبي عند كلِّ قارئ، وأغلب القراء يرفضون المضاعفة والإضافة على ما يقرؤون، خاصةً إذا كان المقروء شعرًا، لأنَّ الانتقال من القراءة إلى الإضافة والمضاعفة والاقتراح يدخلهم في دوامة النقد، وهذا معناه فقدان شهيَّة القراءة. لذلك حين تقرأ بعض المقاطع ترى نفسك تعيدها وتستظهرها، تريد غرسها كما هي:
زهرةُ الحُبِّ مثلُ الحياةِ ومثلُ الكتابةِ
تبزغُ في آخرِ الليلِ من فجوةِ العدَمِ
يكفي للقارئ أنَّ يشعر بالجمال يطير من كلِّ الأنحاء كما الفراشة؛ وليس الجمال جمال الصور فقط، بل الدلالات والرموز والمفردات. وهنا يأتي الوضوح، لا ينتقص الوضوح من الكتابة، بل هو الكتابة نفسها، وكم من مرة أدخلنا الغموض في متاهة الهروب والردَّة. وتبقى حدود التلقي مرسومة بيد الشاعر، فالشاعر من يختار وضعها وبالتالي إقامة علاقة سهلة أو صعبة مع القارئ، وإن كانت صعبة سنصفها معشر القراء بأنّها عدوانية وانتقائية، لكنِّي أظنها المخيلة والمخيلة تصدم كما الواقع تمامًا.
آهِ يا وردتي العصبيَّةَ
يا طيرَ روحي المهاجرَ آخرَ هذا النهارْ
اطفئي جمرَ قلبي بناركِ يا لعنةَ الماءِ والجلَّنارْ.







.png)
 11 الشهور منذ
25
11 الشهور منذ
25






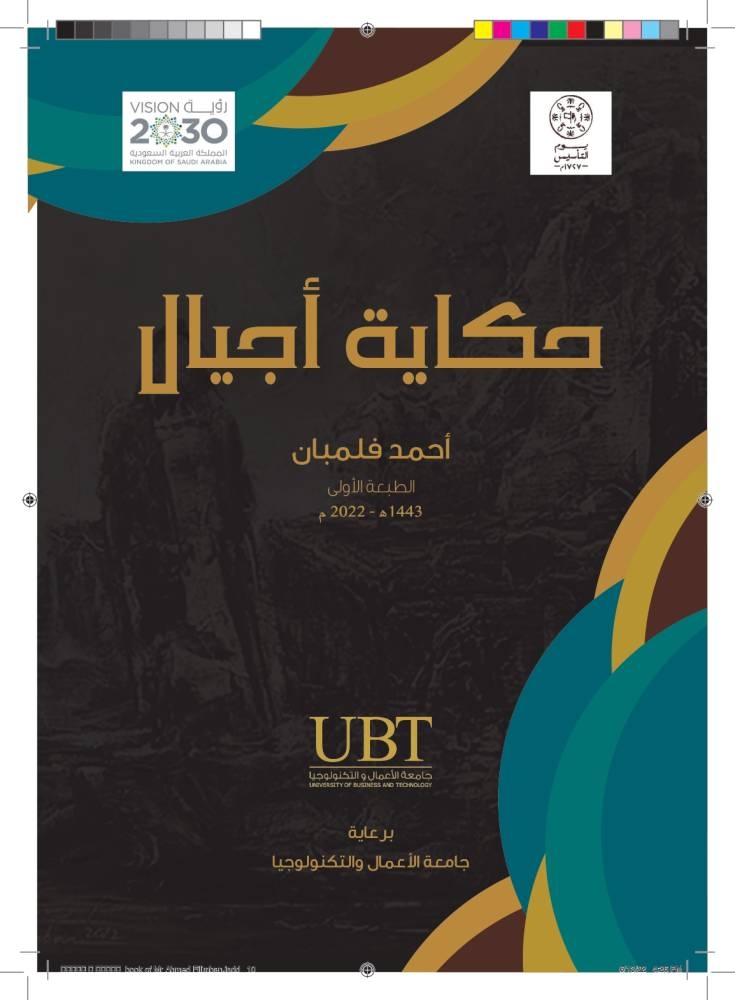

 English (US) ·
English (US) ·